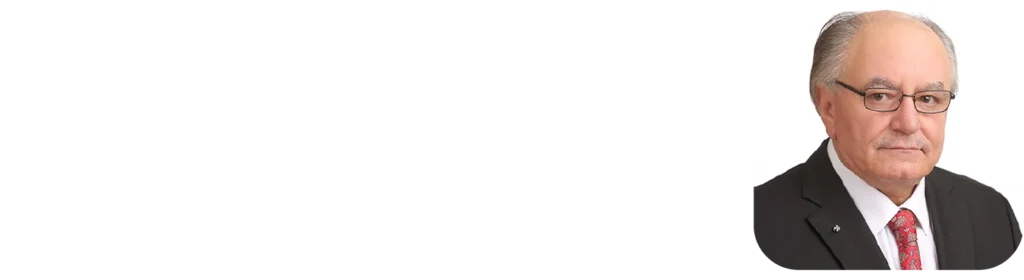وبهذا الخصوص أكد الخبير الدولي في مجال الأمن الغذائي، الدكتور فاضل الزعبي، أن النظام الغذائي في الأردن يواجه هشاشة واضحة أمام التغير المناخي، مشيرًا إلى أن المملكة تُعد من أكثر عشر دول في العالم شحًّا بالمياه، إذ لا يتجاوز نصيب الفرد السنوي من المياه 90 مترًا مكعبًا مقارنة بالخط العالمي للفقر المائي البالغ 500 متر مكعب. وقال الزعبي، خلال حديثه لـ”صدى الشعب”، إن هذا التحدي يمكن تحويله إلى فرصة استراتيجية عبر تنظيم الإنتاج الزراعي وفق احتياجات السوق وكلف المدخلات، ما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد وتحقيق التوازن بين العرض والطلب. وأضاف أن منظومة تنظيم الإنتاج الزراعي في الأردن تلعب دورًا محوريًا في رفع جودة المنتجات وضمان توافقها مع متطلبات الأسواق المحلية وأسواق التصدير، من خلال التخطيط الزراعي الاستراتيجي والتعاقدي الذي يوجّه المزارعين نحو المحاصيل ذات القيمة العالية والقدرة التنافسية. وأشار إلى أن هذا التوجّه يسهم في تقليل الهدر الذي يصل في بعض المحاصيل إلى ما بين 25 و30 بالمئة من الإنتاج، ويرفع الكفاءة المائية، ويعزز القدرة على مواجهة موجات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، لافتاً أنه يصبح النظام الغذائي نفسه أداة للتخفيف من الانبعاثات عبر تقليل الفاقد وتحسين استخدام الموارد. الزراعة تستهلك 52% من المياه وتنتج 6% فقط من الناتج المحلي وبيّن أن الأمن الغذائي في الأردن مرهون بكفاءة إدارة كل قطرة ماء، لافتًا إلى أن الزراعة تستهلك نحو 50 إلى 52 بالمئة من الموارد المائية، بينما لا تسهم بأكثر من 5 إلى 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح أن تنظيم الإنتاج الزراعي يشكّل أداة فاعلة لتوجيه المزارعين نحو محاصيل أقل استهلاكًا للمياه وأكثر ربحية، مثل التمور والخضار المحمية. وأشار إلى أن التجربة الأردنية في إعادة استخدام المياه المعالجة، والتي تجاوزت 190 مليون متر مكعب سنويًا تُستخدم في الري، إلى جانب توسيع الري بالتنقيط الذي يغطي اليوم أكثر من 70 بالمئة من المساحات المروية، تمثل نموذجًا يمكن تعميمه إقليميًا. ولفت إلى أن تذبذب الإنتاج الزراعي المحلي الناتج عن التغيرات المناخية وشح الموارد المائية وارتفاع كلفة مستلزمات الإنتاج أعاق النمط الإيجابي المتصاعد في مؤشرات استقرار الأمن الغذائي الوطني. وأكد أن الحل يكمن في ربط إدارة المياه بتنظيم الإنتاج الزراعي، بحيث يصبح الأمن الغذائي أكثر استقرارًا رغم الضغوط المناخية والديموغرافية، خصوصًا مع توقع ارتفاع عدد السكان إلى نحو 12 مليون نسمة بحلول عام 2030. إعادة تصميم سلاسل الإمداد للحد من الفاقد وأوضح أن الفاقد الغذائي في الأردن يُقدّر بنحو 30 بالمئة من الخضار والفواكه قبل وصولها إلى المستهلك، مؤكدًا أن إعادة تصميم سلاسل الإمداد الغذائي تبدأ من الحقل عبر التخطيط الزراعي التعاقدي، مرورًا بعمليات النقل والتخزين والتبريد. وبيّن أن هذا التوجّه يضمن الاستجابة المباشرة لاحتياجات السوق المحلي وخلق فائض نوعي قادر على المنافسة في الأسواق الخارجية. وأضاف أن تطوير سلاسل تبريد منخفضة الكربون وتبنّي الطاقة الشمسية في التخزين والنقل يمكن أن يخفض الانبعاثات بنسبة تتراوح بين 15 و20 بالمئة، ويزيد من العمر التسويقي للمنتجات الزراعية، ما يعزز الاستدامة المناخية ويضاعف العائد الاقتصادي. وأشار إلى أن المؤسسات البحثية الأردنية، مثل المركز الوطني للبحوث الزراعية، تعمل على تطوير أصناف مقاومة للجفاف والملوحة، بينما يمتلك القطاع الخاص القدرة على الاستثمار في الزراعة الدقيقة والطاقة المتجددة، ما يرسّخ مفهوم الزراعة الذكية مناخيًا. وقال إن مؤشرات التغير المناخي بدأت تتضح تدريجيًا مع تصاعد الظواهر المناخية المتطرفة، مما يستدعي تبنّي أنماط زراعية جديدة للتكيف مع هذه التحولات. وأضاف أن البيئة التشريعية في الأردن تحتاج إلى مزيد من الحوافز الضريبية والتمويلية، مبينًا أن دعم الاستثمار في الزراعة الذكية مناخيًا يمكن أن يرفع الإنتاجية بنسبة 20 إلى 25 بالمئة، ويخفض استهلاك المياه بما يقارب 30 بالمئة. 20% من كلفة التشغيل يمكن توفيرها عبر الطاقة المتجددة وقال إن أبرز الفرص التي يمكن أن يستفيد منها الأردن خلال العقد المقبل لتحويل التحديات المناخية إلى مكاسب في مجال الأمن الغذائي، هي تنظيم الملكية الزراعية وإيقاف تدهور الأراضي، موضحًا أن عدد الحيازات الزراعية ارتفع من 57 ألفًا و400 عام 1983 إلى أكثر من 91 ألفًا و500 عام 1997، مع انخفاض متوسط المساحة من 64.3 إلى 41.5 دونمًا. وأضاف أن معالجة هذه الظاهرة عبر الدمج الطوعي وتمكين الشباب ستفتح المجال لتطبيق التقنيات الحديثة وزيادة الجدوى الاقتصادية، إلى جانب التخطيط التعاقدي المرتبط بالسوق الذي يرفع القدرة التنافسية ويقلل الفاقد، خصوصًا في محاصيل التصدير مثل التمور التي تجاوز إنتاجها 30 ألف طن سنويًا. وأشار إلى أهمية تكامل المياه والطاقة والغذاء، حيث يمكن لمشاريع الطاقة الشمسية في البنية التحتية المائية والزراعية أن توفّر ما يقارب 20 بالمئة من كلفة التشغيل. كما دعا إلى تطوير سلاسل تبريد وتصنيع منخفضة الكربون لرفع القيمة المضافة للتمور والخضار والفواكه، مؤكدًا أن تحسين الجودة وتقليل الفاقد يمكن أن يضاعف عوائد التصدير. وقال إن تنظيم الإنتاج الزراعي هو العمود الفقري لتحويل التحديات المناخية إلى فرص، إذ يربط بين كفاءة المياه واستقرار الأمن الغذائي وتقليل الفاقد وتحفيز البحث والابتكار. وأكد أن النظام الغذائي الأردني، من خلال هذا التنظيم، يمكن أن يتحول إلى نموذج إقليمي في الصمود المناخي، وأداة فاعلة للتخفيف من آثار التغير المناخي وتعزيز مكانة الأردن في الأسواق الإقليمية والدولية.